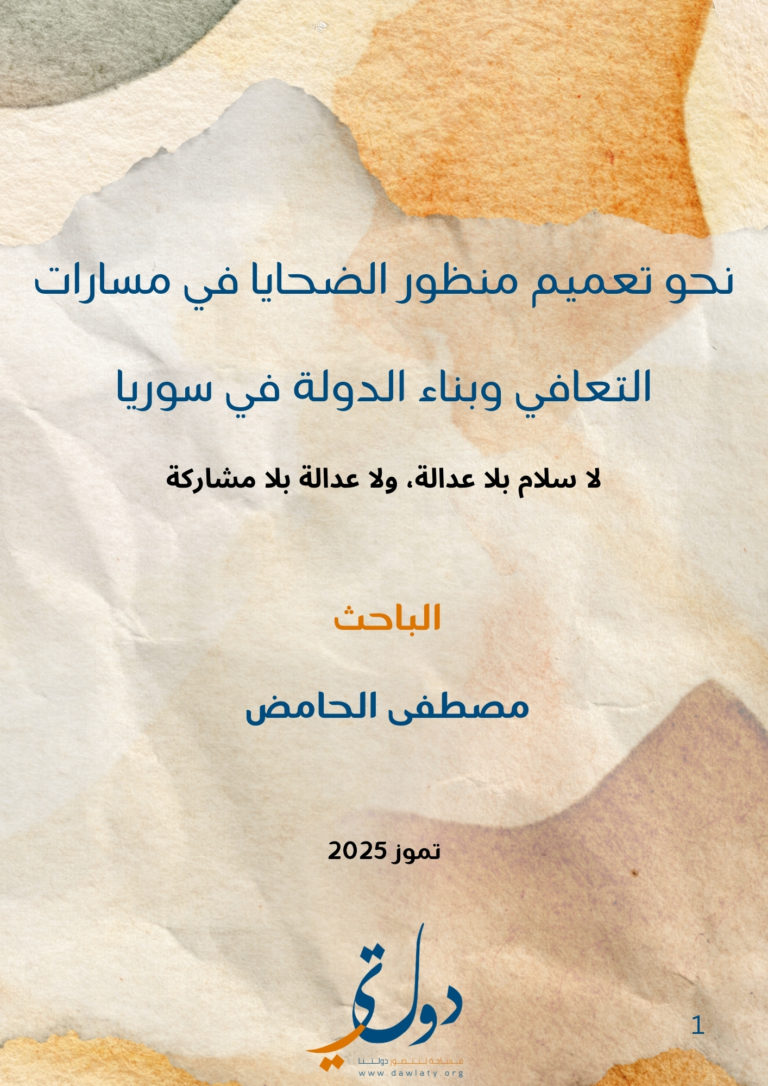زياد ماجد02.01.2012 يحاول هذا النص تحليل بنية الحكم الاستبدادي لفهم أسباب نجاحه في بسط سلطته وفي تعطيل الحياة السياسية وترويض الناس والاستمرار في الحكم لسنوات طويلة. ويتّخذ النص من النظام السوري في الفترة الممتدة بين العام 1970 (عام “الحركة التصحيحية” التي قادت حافظ الأسد الى سدة الرئاسة) والعام 2000 (حين وافت الرئيس المنية) حقلاً لدراسته.ومن الضروري الإشارة الى أنّ جوانب عدّة من تحليل عهد الأب ودراسة المجتمع السوري في ظلّه قد طُوِيت منذ فترة ولم تعد تصلُح لقراءة سوريا السنوات الأخيرة. كما أن الثورة السورية ظهّرت وقائع جديدة في ما خصّ تحالفات السلطة وتركيبة المجتمع، كتب عنها عددٌ من الكتّاب السوريين (وما زال بعضُهم يكتب)، وسيتطلّب توثيقها وتحليلها وقتاً إضافياً. عن بدايات حكم النظام “البعثي” لسوريا إن أول ما يفسّر نجاح النظام السوري في ترويض الحياة العامة بما هي مشاركة سياسية ونشاط إجتماعي وسلوك مواطني، هو قدرته التدريجية على مصادرة الحيز العام ومساحات التعبير وكل فُسح التجمع والانتظام السياسي من خلال الاستيعاب أو الإقصاء. أي أن ما اعتبره ميشال فوكو في وصف التسلّط بأنه “فعل على الفعل” مارسه النظام السوري الى أقصى الحدود بحيث تسلّط بالدرجة الأولى، من خلال قانون الطوارئ للعام 1963 وغيره من القوانين التأسيسية للحكم البعثي، على مواقع المجتمع التي يمكن أن ينطلق منها الفعل السياسي. فأطبق على النقابات والأحزاب والصحف وحاصر القانونيين والمثقفين وسائر قوى المجتمع المدني، وألغى فاعليّتها في مراكز صنع السياسة ومجالات فعلها. وقد شرّح نقولاس فان دام وعددٌ من الباحثين مكوّنات النظام الطائفية والإثنية وصراعاتها التنافسية ضمن المؤسسة العسكرية وحزب البعث الحاكم منذ انقلابه واستلامه السلطة. لكن تشريحهم، على دقّته في توصيف النظام، لا يتناول مختلف جوانب تحالفاته. بهذا المعنى، فإن ما تذهب إليه إليزابيت بيكار من أن دراسة الطبقات والشرائح الاجتماعية التي يتكئ إليها هذا النظام وأشكال عملها وديناميات علاقاتها يفيدنا لتوسيع حدود التعريف خارج الجهات القيادية (الطائفية أو الإثنية) وآليات تنافسها على السلطة. فإذا كان النظام قد إتّكأ في انقلابه الى ركائز طائفية (العلويون بخاصة) وعسكرية (الجيش) وحزبية (البعث) ووُفّق في ربطها ببعضها من خلال توحيد مراكز النفوذ فيها (ضباط بعثيون أكثرهم من الطائفة العلوية)، إلا أنه عكس منذ بداية صعوده ديناميات إجتماعية متنوعّة. فبحسب حنا بطاطو، كان التحالف الذي قاد البعث في سنواته الأولى (1963-1968) قائماً بين جماعات داخل الجيش يتقاسم معظمها جذوراً وتوجهات ريفية متشابهة (أقصى بعضها البعض الآخر في مراحل لاحقة)، وكانت تضم في البداية: “علويين من محافظة اللاذقية، ودروزاً من جبل العرب، وسنة من منطقة حوران ومن محافظة دير الزور ومن بلدات ريفية صغيرة متعددة. وكان هؤلاء جميعاً من أبناء المزارعين الصغار الذين يبيعون منتجاتهم في أسواق يسيطر عليها تجار دمشق، الذين كانوا ينجحون على الدوام في حمل الحكومة على الاستجابة لرغباتهم. فكانوا، لذلك، قادرين على فرض شروط المتاجرة بأساليب تلبي مصالحهم. وصارت علاقتهم بالمزارعين (لا سيما الحورانيين منهم) علاقة دائنين بمدينين… وكذلك الأمر بالنسبة الى علاقة حلب بدير الزور وحماه بمحيطها الريفي”… لذلك لم يكن مفاجئاً الانتقام من “المدينة” الذي شهدته تلك الفترة البعثية الستّينية (من خلال التضييق على تجّارها وصناعيّيها والنزوع الى مصادرة أملاكهم)، والذي أخذ أشكالاً أخرى بعد سنوات، أي بعد تسلّم الأسد مقاليد السلطة عام 1970. فالحاكم الجديد الذي أطلق حركته “التصحيحية” غيّر أساليب الانتقام من المدن، واهتدى الى النصيحة الماكيافيلية التي تدعو لاستبدال خنق المدن باحتلالها وتملّكها. وهو، لتحقيق ذلك، شجّع الهجرات الريفية إلى قلبها ووسّع ضواحيها. ثم نسج علاقات مع تجّارها ورجال الأعمال فيها، وأفهمهم أن أعمالهم تزدهر إن أمّنوا له الولاء وابتعدوا عن المجال السياسي. وتلاحظ إليزابيت لونغينيس أن المدن التي شهدت هجرات ريفية كثيفة، أي تلك التي اخترق نسيجها “الأمير الجديد” وسكنها، مثل العاصمة دمشق، إستكانت لسلطانه وصارت أسهل قيادة من تلك التي ظلّت بناها الاجتماعية أكثر تماسكاً. أما لماذا تراجعت سائر المدن في ما بعد؟ فالعبرة أو العظة جاءتها عام 1982 من تجربة مدينة أخرى، هي حماه، عاد “الأمير” فيها عن نصيحة ماكيافيللي بالاحتلال، وانتقل الى خيار التدمير. وأعطى حريق حماه، وغيره من الحرائق المتنقلة في البلاد، وما رافقها وتلاها من حملات اعتقال وتشريد طالت عشرات آلاف السوريين، هالةً لجيش النظام وأجهزته الأمنية وعنفها الضارب الذي لا يعفي أحداً إن تعرّض لتهديد أو تحدّ. تثبيت السلطة والقمع ومأسسة الاستبداد لاستكمال “تثبيت” السلطة، عبر احتلال المدينة، واصل النظام توسيع القطاع العام واستقطاب الموالين إليه وتركيز أعمالهم في المدن، لا سيما في العاصمة. فارتفع (بحسب بطاطو) عدد مستخدمي الدولة من 34000 سنة 1960 الى 331000 سنة 1980، وتوسّعت بالتالي قاعدة النظام داخل المؤسسات، وراحت تتمدّد من خلال إدارتها للمصالح العامة وتحكّمها بخدمات المواطنين. ورافق تضخّم القطاع العام في منتصف السبعينات، وبعكس حالات كثيرة، ازدهار في أعمال القطاع الخاص وتجارته في معظم المدن نتيجة الرجوع عن بعض سياسات التأميم الصناعي من جهة، والطفرة النفطية وتدفّق المساعدات الخليجية بعد حرب تشرين مع إسرائيل في العام 1973، و”التدخل” السوري في لبنان عام 1976 وما أمّنه من موارد “ثابتة” من جهة أخرى. فساهم ذلك أيضاً في تكريس علاقات النظام مع بعض وجهاء المدن وبورجوازياتها. إلا أن هذه العوامل مجتمعة (توسّع القطاع العام، تحسّن أحوال القطاع الخاص، تدفّق المساعدات والتحويلات نتيجة الطفرة النفطية ومن ثم الحرب اللبنانية) أدّت في ما بعد الى ظهور “طبقات بورجوازية” جديدة، يميّز فولكر بيرتس بينها معتمداً تصنيف “الصناعيين الجدد” و”بورجوازية الدولة” و”الطبقة الجديدة”، أي الطفيلية التي اغتنى المنضوين فيها خلال الصفقات والرشاوي وعمليات التهريب المغطاة من رجالات النظام. ووسّعت هذه الطبقات مع الوقت من قاعدة النظام الاجتماعية. بموازاة ذلك، سيطر النظام على أكثر الأحزاب السياسية من خلال استيعابها والتسبب بالانقسامات في صفوفها. فأنشأ “الجبهة الوطنية التقدمية” عام 1972 ضاماً إليها أحزاباً شيوعية وقومية واشتراكية بقيت واجهة من دون مشاركة فعلية في القرار، وشكّلت في الوقت عينه تغطية للكثير من سياسات النظام وإجراءاته وامتداداً له نحو قواعد لم يكن ليحيّدها بسهولة عن العمل السياسي. وهي أيضاً ساعدته على نحو غير مباشر في زج “المنشقين” عنها أو الخارجين من صفوفها الرافضين الدخول في الجبهة بالسجون (لا سيما في حالة الحزب الشيوعي).كذلك، قام النظام بالإمساك بالنقابات العمالية، منسّباً (بحسب لونغينيس) ما بين 95 و99 في المئة من عمّال القطاع العام إليها، ومحولاً إياها الى أدوات “لكوربوراتيسم الدولة” الجديد.أما القضاء، فقد جوّفه وفرض المحاكم الاستثنائية والعسكرية كما المُحاكمات على أساس قانون الطوارئ لتهميش سلطته وتحطيم هيبة أفراده… تُظهر هذه العوامل أن النظام الحاكم بقيادة حافظ الأسد تخطّى مع مرور الوقت الشكل الذي كان اتخذه النظام البعثي منذ استيلائه على السلطة وحتى نهاية العقد الأول من عمره (1963-1973)، على أنه حكم “عسكري”، ليصبح حكماً ذا عصبية عسكرية، لكن بتحالفات وامتدادات ضمن طبقات اجتماعية وشرائح من فئات ومناطق مختلفة صعدت معه واستفادت منه وكوّنت مواقع نفوذ وجاه وتأثير ليس من السهل إزاحتها عنها لتحالُفِها مع بعضها ودفاعها عن مصالحها المشتركة رغم ما قد يشوب علاقاتها من تنافس وتنافر. وبالمحصلة، صار المجتمع السوري المطوّع لصالح نخب حاكمة (يقودها مايسترو واحد) معطلاً، تصول فيه وتجول شلل تمارس الفساد والسطو، محوّلة ممارساتها ليس الى سلوكيات مقبولة فحسب، بل وضرورية لتثبيت السلطة والمواقع الحكومية. ويصف يحيا سادوفسكي هذه الحال حين يقول “لا مشكلة مع الفساد طالما أظهر القائمون به ولاءهم للنظام. فالفساد يصبح بهذا المعنى شبكة من شبكات النظام ووسيلة لاستقطاب مجموعات من مختلف الفئات والطبقات”. لكن هل من تفسيرات أخرى لأسباب نجاح النظام في السيطرة على المجتمع؟ ولماذا استدامت هذه السيطرة بعد منتصف الثمانينات وانتفت مقاومة المجتمع “للدولة” البعثية التي استوحى ميشال سورا “التناقض الهيغيلي الماركسي” لوصفها، معنوناً أحد مقالاته “المجتمع السوري ضد دولته”؟ هل يفيد التفكّر في العلاقة الشائكة بين “السياسي-العسكري” من جهة و”الاجتماعي-الاقتصادي” من جهة ثانية، لفهم ما جرى؟ وهل يمكن اللجوء الى خلاصة خلدون النقيب في أن الحكم الذي يبدأ تحت أمرة العسكر، ينتهي الى “البرقرطة والتسلط وترييف المدن” للإجابة؟ لا يبدو ذلك على الأرجح، رغم صحّته، كافياً في الحال السورية لفهم الأسباب كاملةً لما بدا ترويضاً للمجتمع، ذاك الذي سبق وأنتج حيويّات وتحوّلات سياسية متواصلة خلال العقود الأولى التي تلت استقلال “الدولة” السورية وسبقت دخولها “الحقبة الأسدية”. لعل الفقرة التالية تقدّم إسهاماً إضافياً في الجواب عن هذه الأسئلة… في ثقافة النظام و ممارساته و انعكاساتها على المجتمعمن أهمّ ما بناه النظام في سوريا في عهد الأسد الأب، ذلك المزيج بين “الشخصنة” التي يتمحور حولها كل إنجاز ويتحوّل عبرها التراجع تقدماً من ناحية، و”المأسسة” للأدوات القمعية والرقابية التي تدير شؤون البلاد والعباد من ناحية ثانية. وخلق هذا النظام عبر مزيجه المذكور مستويين في التعامل مع المجتمع، وفي الخطاب والممارسة المتبادلة بينهما. الأول ملموس ومادي، والثاني رمزي ومعنوي. وهو في كليهما اعتمد نمطي القيادة اللتين حلّلهما ماكس فيبير، الكاريسما والتنظيم. ففي التنظيم، أسّس الأسد أجهزة ومراكز قوى تأتمر به مباشرة عبر المخلصين المزروعين فيها (والمتخاصمين في أغلب الأحيان في ما بينهم)، بحيث تعدّدت الأجهزة المخابراتية المتنافسة، تتقدّمها “المخابرات الجوية”، واخترقت كل انتظامات المجتمع، ثم راح يراقب الواحد منها البقية. وتمارس هذه الأجهزة العنف من خلال اجتياح حياة المواطنين الخاصة، ومنعهم من التعاطي بالحياة العامة، والزج بهم في السجون أو حتى إرسالهم الى القبور إن اقتضى الأمر. ونجح هذا الجو من الرعب والتسلط مع الوقت في تحويل العنف رمزياً في أكثر الأحيان. فيكفي أن يخاف الناس من بعضهم ويراقبوا ذواتهم ويقمعوا آراءهم كي يستتبّ الأمر للأجهزة وتطمئن الى سيطرتها.وفي التنظيم أيضاً، شكّل حزب البعث، بموازاة الجيش والبيروقراطية والقوى المخابراتية المختلفة، أداة أخرى للنظام. فمن خلال منظمّاته الشعبية التي تضم الاتحادات النقابية والشبابية والنسائية والفلاحية، وإيلاء فروعه مهمة مراقبة المدارس ومناهجها والإعلام العام وبرامجه، وتقديم منح التخصص وتوفير فرص العمل، سيطر هذا الحزب على الحياة العامة في سوريا. أما على صعيد الكاريسما والشخصنة، فلم يبدُ الأسد قائداً لمجتمعه ونظامه فحسب، بل أيضاً وسيلة لإقناع الناس بما ينبغي الاقتناع به. بمعنى آخر، فهو الى إحاطته نفسه بألقاب ونشرها تحت صوره المنتشرة في كل أرجاء سوريا، يخلق حقائق و”يُلزم” الجميع بتصديقها (مركّزاً الى حد بعيد على ما يعتبره سجلاً ناجحاً في السياسة الخارجية). فالأسد هو “القائد والرمز وبطل تشرين، وهو صلاح الدين القرن العشرين. وهو أيضاً باني سوريا الحديثة الذي أمّن لها الاستقرار والتقدم وحوّلها قوة عظمى إقليمية متحالفة مع الاتحاد السوفياتي (أي مع عمال العالم). وهو حمى لبنان من التقسيم ومنع إسرائيل من القضاء على الفلسطينيين ووقف سداً في وجه كل المؤامرات التي حاكتها الامبريالية والصهيونية ضد شعوب العرب ودولهم”. هكذا تصوّره وسائل الإعلام، وهكذا يظهر في الملصقات، وهكذا تقول الهتافات لحظة ذكر اسمه. تقدّم الباحثة ليزا ويدين تحليلاً عميقاً لظاهرة “عبادة الأسد” في سوريا. والمثير في عملها أنها لا تعتبر أن هدف عبادة الأسد هو إيجاد إيمان أو التزام عاطفي حقيقي لدى المواطنين به، بل تحديد شكل ومضمون للطاعة المدنية المطلوبة منهم “للمعبود”: “فبالإضافة الى السلاح وغرف التعذيب، تهدف ” عبادة” الأسد الى تطويع الناس وفرض مناقبية عليهم يقومون بموجبها بالتصرف وكأنهم يعبدون قائدهم ضمن فلسفة “التصرف وكإننا مصدّقين”. ومن خلال سياسة “العبادة” هذه، هدف النظام الى محاصرة المواطنين ونزع الروابط فيما بينهم وتفتيتهم الى وحدات لا علائق بينها. وحتى حين حاولوا مقاومة ذلك بالتصدي المباشر أو بالتحايل وإطلاق النكات والتلميحات الكاريكاتورية والابتسام الماكر أمام شاشات التلفزة الرسمية لإعادة التواصل في ما بينهم، فقد أكدوا قوة هذه العبادة وسيطرتها عليهم. ذلك لأنهم بالضبط لا يصدقونها. ولشرح ذلك، تنقل ويدين عن الفيلسوف سلوفاج زيزيك أنه “حتى لو حافظ الناس على مساحاتهم الساخرة، وحتى لو أظهروا أنهم لا يأخذون ما يقومون به على محمل الجد، فإنهم يبقون مطيعين. والطاعة هي ما يهم سياسياً”… على سبيل الخلاصة في هكذا حال من الطاعة القسرية إذن، ووسط ثقافة وممارسات وتحالفات وأجهزة قمع من النمط الذي عرضناه، حكم الرئيس حافظ الأسد سوريا ثلاثة عقود وابتنى نظماً وهياكل بعضها منسوخ عن تجارب دكتاتورية كلاسيكية، وبعضها الآخر منطلق من ديناميات محلية. وقد رُبطت جميعها بشعارات تتخطى الحدود “القطرية” لتُصيب فلسطين ولبنان والحرب الباردة. ولا ضرورة للتذكير بكيفية ترجمة هذه الشعارات الى وقائع، وما أمّنه ذلك من دعاية للنظام وأوراق تفاوض إقليمي ودولي، ومداخيل عظيمة الأثر في تأمين استمراريته وتطوير سلوكياته وعلاقاته، لغاية رحيل مؤسّسه قبل إحدى عشرة سنة، وتوريثه المُلك لابنه…المصدر: ziadmajed.blogspot