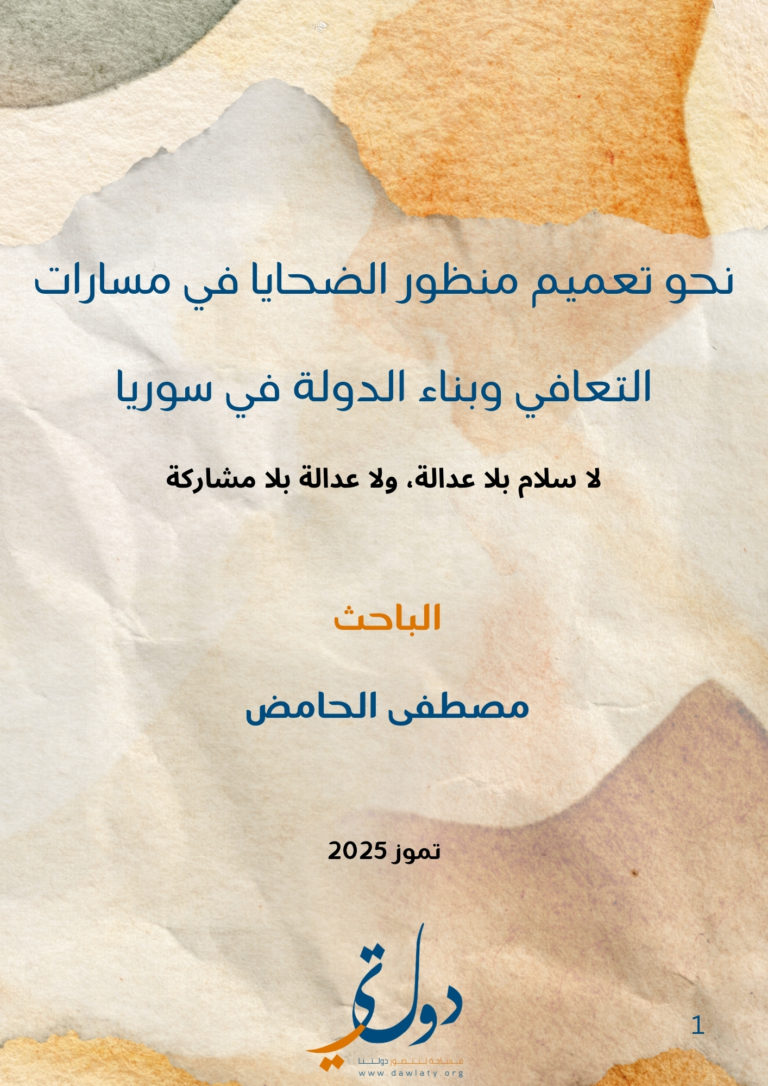عارف حمزة07.12.2012 كان عليّ الاستيقاظ باكراً كي أذهب إلى إحدى مدارس النازحين في حيّ الناصرة في مدينة الحسكة، وآخذ هيلانة الصغيرة إلى الطبيب المختص كي تشفى من العزلة. ولأنّني دائم الحسد لأولئك الذين يُطيلون يومهم، وأعمارهم، بالاستيقاظ باكراً، ولأنني لست من أولئك المسحورين بذلك، فقد سبق أن لم أذهب إلى امتحانات ستّ مواد أثناء دراستي الجامعية في كليّة الحقوق في حلب، بسبب أنّ توقيت تقديمها كان في الثامنة والنصف صباحاً… لذلك لم أنم تلك الليلة كي لا تحتضر ابتسامة هيلانة النديّة بتأخّري عليها. وهي صاحبة الإحسان عليّ في تمرير ذلك الوقت الطويل من الليل الحار بقراءة مئة وسبعين صفحة من الجزء الثاني من ثلاثيّة الصلب الوردي لهنري ميللر. لم أهتمّ بتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولا بمحاولة الشمس أن تقلّب ورقة جديدة من روزنامة المكتب، التي ما زالت متحجّرة في العام 2006، بإطلالتها الكئيبة من بين كتل الإسمنت البشعة التي تخفي جوانب المدينة الفقيرة، والتي يسكنها الأكراد والأشوريون، عن قلب المدينة النقيّ في هذه اللحظات، ولا بأكياس القمامة السوداء التي نثرت محتوياتها القذرة نساء هرمات نحيلات فقيرات بأقدام حافية، اللواتي ينحين على الأرض، ضد فكرتهنّ عن السماء، كما تعودن أبداً، اللواتي سيجدن أشياء أهملتها القطط في دوامها الليلي الطويل. ولا لخيال الأطفال الذين كانوا يذهبون نائمين إلى المدارس، بينما أجسادهم الآن تنعم بالنوم العميق، ولا لعدم وجود ورد لم يصل إلى الشرفات فسقط في الأنحاء… بل لرائحة القهوة التي تنبعث من بيوت قليلة داومت على وهم التحضّر، ولخرمشات قطط دقيقة في رئتيّ بسبب التدخين الكثيف، وفي النهاية، لعمال النظافة القليلين الذين لا يُخفون وجوههم، في هذه الأوقات الناصعة، كي لا يخجل الأحفاد.أعرف أن هيلانة تنتظرني الآن بفستانها الأصفر المطعون بالأخضر القويّ طعنات كثيرة، وهي تستند بظهرها إلى الحائط البارد لإحدى المدارس التي تحمل اسم شهيد في حرب غامضة. الثوب الأصفر الذي كانت ترتديه عندما جاءت “الفان” المهترئة كي يهربوا من القصف على حيّها المنكوب في دير الزور.أخذوها من فراشها القديم كما التقطوا بعض الأشياء التي كانوا يظنون أنّها مهمة، بينما تركوا كلّ شيء أكثر أهميّة لرحمة الذكريات. “أريد أن أصبح لاعبة كرة قدم”. قالت لي في زيارتي الأولى لها قبل يومين.”عندما كنتُ صغيرة كنتُ أريد أن أصبح ليمونة”! نعم ليمونة كانت تريد أن تتخرج من إحدى الجامعات. وكان الجميع يستهزئون منها، في البيت والمدرسة والشارع، لدرجة أن والدها، الذي يعمل في سوق الخضار، فكّر جدياً أن يأخذها لرجل دين، بعد أن كان يضحك سابقاً من عسل براءتها تلك. هيلانة تعاني من نقص حاد في رؤيتها، وذهابي إليها ، في إحدى استيقاظاتي النادرة، كان لأخذها إلى طبيب العيون لمعاينتها، ووصف عدسات طبية لها، بعد أن عاشت في عزلة كبيرة، في مقبرة النزوح هذه، لأنّ أهلها نسوا أن يلتقطوا “نظاراتها” الطبية عندما سحبوها من مناماتها الضبابية. طوال شهرين كانت هيلانة تبتعد أكثر فأكثر عن الشارع ثم باحة المدرسة، التي نزحت عائلتها الكبيرة إليها، ثم كلّ أترابها. وكلّما مضتْ صارمة في عزلتها البهيّة تلك كان أهلها يفكّرون في معنى علاقة الرؤية بالعزلة ومرض الوحدة، الغريب عن جذورهم، لليمونة صغيرة ما عادت ترى حتى الغصن الذي يحملها. فاجأها والدها، الذي بات يقضي يومه هنا في القهوة منتظراً أخبار القتلى وكميّة الخراب التي تأتي من دير الزور بسرعة أكبر من سرعة الحافلات التي ما عادت تذهب إلى هناك، بهدية جميلة اشتراها بثمن قليل من أمام الجامع الكبير في الحسكة، وكانت نظارة رجالية هي عبارة عن عدسات مكبّرة يستخدمها المهنيّون في تصليح الساعات. وضعتها هيلانة على أنفها المنمّش ورأت أصابعها، من جديد، كحطب بنيّ اللون وكبير. وبعد دقائق، من جمود أصابعها أمام وجهها، رأت ذلك الذئب من جديد يحدّق في وجهها.وضعت هيلانة ذقنها في آلة المعاينة البصريّة مقابل وجه الطبيب الشاب مباشرة، لا يفصل بين شفتيهما سوى القليل من السنتيمترات التي تعادل ثلاثين سنة في علم الأعضاء. كانت جلستها تتغيّر بسرور كلّما وضع الطبيب عدسات تضع الحياة كاملة أمام عينيها. وفجأة انتصب جذعها وصارت تهرش فخذها اليمنى. لقد رأتْ عينيه وعشقتهما. كانت ستقول لو أنها في العشرين. لكنّها كانت في العاشرة وهذا ما دفعها نحو إطلاق رائحة حليب من تحت إبطيها فحسب.لو أنّ هيلانة تداوم في صفّها الآن لكانت دخلت من باب صفّها، وذهبت مباشرة إلى المقعد الأخير، متجاوزة مقعدها الأول الذي داومت عليه طوال اجتهادها الكبير في سنوات الدراسة القليلة، وربّما جلستْ على ركبتيها مقابل الحائط كمحارب جديد في كتيبة التوحّد، ولكانت تجاوزت الحائط نفسه وجلست في قلبه مرتاحة، بسبب الفراغ الذي تعكسه الأشعة مقلوبة في دماغها الصغيرة المملوءة بالحشائش البيضاء.لم تكن تريد النزول عن الآلة، بعد أن انتهى الفحص العينيّ لها، بعد أن رأت نفسها ليمونة صغيرة في عينين خضراوين. عندما طلب الطبيب منها النزول، ليكتب لها دواءها الزجاجيّ الذي ستضعه أمام عينيها الفارغتين لتجمع نثرات الحياة من جديد كصور واضحة، أحسّت هيلانة بالهجران. كانت تريد أن تبقى هناك، في العدسات التجريبيّة الصحيحة، حتى لو أنّها لن تر سوى الحائط البيج الذي خلف حبيبها المعالج. كانت تريد أن تضع أصابعها من جديد لتراها، وقد هرب الذئب إلى مكان بعيد، أبعد من خراب مدينتها.كانت النظارات ستنتهي في المساء، وليس من فائدة لقتل الوقت بقتلها هي في مدينة الملاهي، حيث لن ترى سوى صراخ الأطفال وضحكاتهم في الأنحاء.”أريد بوظة” قالت بخجل الفقير. “بوظة من كلّ الألوان”. تابعت بخجل أقوى وهي تلتفت حولها كي تتأكّد من عدم وجود أحد قد ابتسم باستهزاء. خمّنت بأنها سترفع صحن البوظة إلى وجهها وتأكله بعينيها، وكان تخميني صحيحاً.فكّرت في ولديّ وأنا أمسك بيد ليمونة ضريرة في السوق.كتبتُ عن هيلانة على صفحتي في الفيسبوك قبل يومين:”تقول هيلانة، وهي في العاشرة من عمرها، أنّها من دير الزورولكي تجعلك تفهم معاناتهاترفع يدها اليمنىوتمدّ إصبعاً رقيقاً في بطن الهواءوهي تعرف أنك لو نزلت على ركبتيكووضعت يدك حول خصرهاونظرت إلى ما يشير إليه إصبعهاستصل إلى كفر نبل!!!”.كلّ الأوقات بعد ذلك بدت مؤلمة وفارغة ونحن ننتظر المهنيّ كي ينتهي من صنع عينين زجاجيّتين لهيلانة الساحرة. لم يبق أيّ معنى لأيّ شيء آخر في المشهد الذي تمّ تأليفه بدموع الوالدين والمهنيّ البطيء يضع النظارات على وجه هيلانة. كان وجهها مغلقاً، وليس عينيها فحسب، عندما ثبّتت ساعدَي النظارات على أذنيها. ثم فتحت عينيها، ولم تفكّر أن تقرّب الذئب من وجهها من جديد طالما خرجت الآن من الغابة، بل هرولت لتحضن ركبتي اليمنى، وهي تقول:”عمّو… صرت أشوف…”. المصدر: السفير